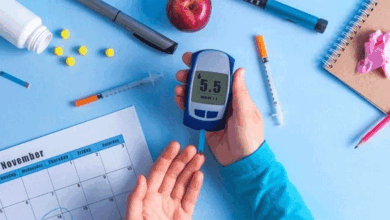“رسالة إلى أم توفيق” .. د.محمد عامر المارديني

|| Midline-news || – الوسط …
.
لم يك ذلك الصباح عادياً كأي صباح يعبر بين أيام حياتي، فعند الساعة السابعة سمعت قرعاً خفيفاً على باب البيت. نهضت من سريري أفتح للطارق، ففوجئت بسيدة كهلة تشي ملامحها أنها في أواخر العقد السادس من عمرها. كانت شاحبة الوجه، ما يدل على تكبدها عناء الطريق سيراً على الأقدام، أو ربما لصعودها نحو عشرين درجة حتى وصلت باب بيتنا. كانت ترتدي معطفاً رثاً، بني اللون، بانت على ظهره وتحت إبطيه هالات من ملح العرق، المتراكم منذ أسابيع، وربما لأكثر من ذلك من دون أن يرى غسلاً. كانت تغطي شعرها برداء أبيض طويل، أما قدماها المنتفختان من احتباس الماء فكانتا سجينتي حذاء أسود مهترئ يدل على ضيق ذات يدها. قلت لها: خيراً؟، ماذا تريدين أيتها السيدة؟ قالت لي بوجه شاحب، وقد بدت على شفتيها الجافتين آثار من زبد: هل لي يا بني بكرسي أجلس عليه فأسترد أنفاسي؟، وكوب من الماء أبل به ريقي؟
أوحى لي ذلك الطلب بأنه طريقة جديدة للتسول، أو ربما عملية سلب أو احتيال تجري بالتنسيق مع مجموعة من اللصوص بعد أن تبدأ بها مثل هذه السيدة باستدرار عواطف الناس البسطاء والسذج، فتوقع بهم بطريقة أو بأخرى، ليحصل ما قد يحصل من سرقة أو قتل، أو ما يشبه ذلك. هكذا يحكى، أو هكذا ما نراه في المسلسلات التلفزيونية على الأقل. لذلك حاولت تجنب تلبية ما طلبت، إنما بشيء من التهذيب قائلاً لها : طيب، يمكنك الاستراحة على الدرج ريثما أحضر لك الماء.
أغلقت الباب جيداً، ثم نظرت من العين الساحرة استطلع شيئاً عن مدى صدقها، وللتحقق كذلك من صحة ما أنا متخوف منه، فوجدتها في تلك اللحظة جالسة على حافة الدرج تلملم خديها المترهلين بكفيها، ثم أغمضت عينيها وغطت في قيلولة قصيرة ريثما آتيها بما طلبت. رجعت إليها بعد قليل حاملاً كوب الماء، ثم ناديتها قائلاً وكأنني أوقظها: يا حجة!!، تفضلي!! أفاقت السيدة من غفوتها القصيرة، فأمسكت بالكأس، ثم شربت منه القليل، ثم قالت لي وهي تتنهد: آه يا بني، هل لي أن أسألك سؤالاً فتجيبني عليه؟ قلت لها بشيء من الاستعجال: تفضلي. قالت: هل تعرف أحداً يمكنه أن يدلني على مكان ابني؟ قلت لها، وقد شككت أن في عقلها لوثة : والله إنه لسؤال غريب، من هو ابنك؟، ومن أين لي أن أعرف أين ذهب؟، ثم لماذا اخترتني أنا من بين كل الناس لتسأليني عنه، وأنت لا تعرفين من أنا؟ ابتسمت السيدة ابتسامة خفيفة فبان لي لسانها أبيض جافاً وكأنه معفر بالكلس، ثم قالت لي: يا بني، الحقيقة أنني اختار كل يوم بناء من أبنية الحارات المجاورة لحارتي، فأسأل أهل هذا البناء ما سألتك نفسه، وإلى الآن لم أفلح في معرفة أي شيء عن ولدي.
بدأ يسري في قلبي قليل من التعاطف مع هذه المرأة، مستبعداً نوعاً ما نظريتي الجنون والمؤامرة، ولا أعرف حقيقة كيف رأيت على محياها وجه أمي، لحظات قبل أن تغط نائمة في سبات عميق، ثم فارقتنا بعد ذلك مسافرة إلى بارئ الروح. قلت لها متعاطفاً: وما خطب ابنك الغائب؟ تنهدت قليلا، فأحسست بحرارة صدرها تلفح وجهي، ثم قالت لي: ماذا أخبرك يا بني؟، إنها رحلة من الشقاء، ما بعدها شقاء. ابني توفيق يعمل بلّاطاً في لبنان، توفي أبوه منذ عامين تاركاً لي ثلاثة أولاد غيره، أكبرهم سناً في الصف الثامن الإعدادي. لتوفيق زوجة ما زالت صغيرة في السن، عمرها الآن نحو ثمانية عشر عاماً، وعلى يدها طفلها الذي كان قد ولد بعد شهر من وفاة جده. يذهب توفيق للعمل في لبنان لمدة أسبوع كامل، ثم يبقى بعدها أسبوعاً بيننا، وهكذا طوال السنة، جيئة وذهاباً. يصرف علينا توفيق كل ما يجنيه من عمله في لبنان.
وبينما هي تتابع حديثها إذا بذقنها يبدأ بالارتجاف، ثم أخذت تنتحب وهي تقول: لكن هذه المرة غادرنا توفيق منذ نحو شهرين ولمّا يعد بعد. لا نعرف عنه شيئاً، ولا أعرف يا بني ماذا أفعل؟، ثم ما لبثت أن غرقت في بحر من الدموع.
لحظات عادت بعدها أم توفيق الغائب للتنهد من جديد بعد أن توقفت قليلاً عن البكاء. قالت لي: توفيق!!، أنت لا تعرف توفيق!! إنه أحن ابن في الدنيا، لن تجد له مثيلاً على هذه الأرض، أقوم ليلاً لأصلي إلى الله وأدعوه أن يحفظه لي، إنه يفكر فينا قبل أن نفكر نحن في أنفسنا، يرعى أخوته اليتامى قبل ابنه الوليد، يطعمهم قبل أن يأكل، يسهر إلى منتصف الليل ليعطيني الدواء، الجميع يناديه بابا، بمن فيهم أنا، فهو أبونا الحقيقي. عدلت قليلاً من جلستي بعد أن بدأت تلك القصة تشدني إلى عالم من الغرابة والضيق وشيء من القلق. قلت لها: ثم ماذا؟ قالت لي : لا شيء، سوى أنني لا أعرف ماذا أفعل، فأين يمكنني البحث عنه؟، أين يمكن أن أجده؟، أخوته وزوجته وابنه يسألون عنه كل يوم، ولا أعرف بماذا أجيبهم. ثم عادت من جديد لتجهش بالبكاء.
ارتبكت كثيراً بعد أن سمعت ما سمعت، فكيف يمكنني مساعدة تلك المرأة المكلومة؟ قلت لها: هل لي أن أعينك ببعض من المال ريثما يعود توفيق؟ ضحكت أم توفيق ضحكة بائسة ثم قالت لي: تصور يا بني أن توفيق غضب مني في إحدى المرات التي استدنت فيها بعض المال من جارتنا أم جمال. قال لي حينها: إياك أن تستديني من أحد يا أمي، إياك أن تعيدي ما فعلت، إياك أن تذلي نفسك لأحد، فأنا مستعد لأقطع من لحمي وأبيعه كرمى لعيونك. ومن حينها وإلى الآن، حلفت ألا آخذ أي قرش من قريب أو غريب، إيفاءً لوعدي له. قلت لها: طيب، وماذا عساي أن أفعل لأساعدك؟ قالت: يا بني، خذ هذه صورته!!، وهذه صورة هويته الشخصية!! فإن كنت تعرف مسؤولاً ما على الحدود، أو في لبنان، أو في أي مكان في الدنيا، فاسأل عنه!!، وساعدني كي أجده!!، فلك بذلك ثواب من عند الله!!، ودعاء من أخوته وزوجته وابنه!!، ومني أنا كذلك، ليل نهار. قلت لها بحماسة بالغة، بعد أن أقلقني فعلاً غياب توفيق عن هذه العائلة البائسة: سأفعل يا حجة ما أستطيع فعله، لكن كيف أستطيع التواصل معك؟ قالت: هذا رقم هاتفي المحمول، يمكنك الاتصال بي في أي وقت تشاء. ثم قالت لي بعد أن عادت لتذرف دموعها بسخاء: أرجوك أن تطمئنّي عليه، وأنا بالمقابل سأدعو الله أن يطمئنك على أحبابك. أرحني يا بني!!، أسعدك الله. ثم ما كان منها إلا قبضت على كفي بكلتا يديها محاولة تقبيله، فسحبت يدي بسرعة مستغفراً الله، ومن دون أدنى تفكير أمسكت أنا بيدها، وطبعت عليها قبلة، مودعاً.
ذهبت أم توفيق ولسانها يلهج بالدعاء لي. نادتني زوجتي بعد أن انتهت في تلك اللحظات من تحضير طعام الفطور لتسأل من كان على الباب. قصصت عليها ما دار بيني وبين أم توفيق، فما كان من عينيها إلا أن بدأتا تدمعان تعاطفاً مع قصتها، وكأنهما تتوسلان إلي أن أساعدها. قالت لي زوجتي : هكذا هو قلب الأم، تلك المسكينة. أنا أعرف أن لك من المعارف ما يمكنك أن تساعدها، فقصتها والله تحرق القلب، أرجوك افعل شيئاً!!
وبالفعل حسمت أمري ببذل الممكن، وما هي إلا دقائق حتى بدأت اتصالاتي من هنا إلى هناك، بحثاً عن رأس الخيط، حتى أنني اتصلت ببعض الأصدقاء في لبنان. كلمتهم ورجوتهم المساعدة، وحاولت قدر الإمكان استثمار جل معارفهم بحثاً عن توفيق. وبالصدفة استطعت الحصول على هاتف سائق السيارة التي كانت تقل توفيق وزملاءه في العمل إلى لبنان. اتصلت به مساءً استفسر عنه. قال لي السائق : أرجوك!!، هناك كلام لا يقال على التلفون!!، هل لي أن أراك غداً؟ قلت له بحماسة لا متناهية: ولماذا غداً؟، دعنا نلتق اليوم. قال لي: لا يمكن، أنا في طريقي إلى بيروت، ولا أعود إلا مع ساعات الفجر. سأتصل بك غداً لمجرد وصولي، ونلتقي.
وهكذا كان اللقاء في اليوم التالي. قلت للسائق مستعجلاً: هيا قل ما عندك!! اقترب مني قائلاً بصوت خافت، وكأنه الهمس: سحبوه احتياط!! قلت له: كيف؟ قال لي: كنا في طريقنا إلى لبنان عندما توقفنا عند أحد الحواجز العسكرية. ناداه ضابط المجموعة قائلاً له، بعد أن قام “بتفييشه”: توفيق!!، أنت مدعو للاحتياط. قال له: وكيف ذلك؟، أنا معيل لعائلتي. إخوتي صغار، وأبي متوفى، وكل ذلك مثبت على دفتر خدمة العلم. قال له الضابط وكأنه متعاطف معه: أنا متأسف، أسمك موجود في القوائم الجديدة، ولدي أمر بسوقك على الفور. ودعني توفيق بعد أن أعطاني عشرين ألف ليرة قائلاً لي: أرجوك أن تعطيها لأمي، وقل لها إنني بخير وإنني ذاهب لخدمة وطني، وسأعود قريباً بإذن الله، وقل لها كذلك ألا تشغل بالها بشيء، فمصروف البيت سيصلها كما كان من ذي قبل. سجلت رقم أمه على هاتفي، ثم قلت له: لا تشغل بالك يا صديقي، سيصلها ما أعطيتني، وسأقول لها ما لقنتني إياه. غادر توفيق السيارة بعد أن ودعنا بضمة إلى الصدر، ودعونا له الله أن يرده إلينا سالماً غانماً.
قال لي السائق: عدت بعد ذلك من بيروت إلى دمشق لأتصل بأم توفيق، وإذ بهاتفي المحمول قد سقط مني على الأرض متحطماً من دون أن أستطيع إنقاذه، أو حتى إنقاذ أي رقم من الأرقام المسجلة فيه. حزنت كثيراً، فكيف لي الآن أن أتصل به، أو بأمه؟ مع ذلك استطعت أن أحصل صدفة على رقم هاتفه من أحد زملائه في العمل، الذين كانوا يسافرون معي. حاولت بعد ذلك الاتصال به مراراً، لكن من دون جدوى، فهاتفه كان على الدوام خارج التغطية. وها أنت يا سيدي قد أتيت إليّ من عالي السماء، فخذ بالله عليك هذه الأمانة لأمه!!، وإن استطعت الاتصال به فطمئني عليه!!
ودعني السائق، على أمل معاودة الاتصال فيما بيننا، إن سمع أحد منا أي شيء عن توفيق الغائب.
لم أشأ في تلك اللحظة أن أخبر أمه بما قد جرى. قلت في نفسي: فلأفتش عنه أولاً ثم أتفق معه على “سيناريو” لطيف يخفف قليلاً من عذاب الفراق عن عائلته.
اتصلت ببعض الأصدقاء الذين يمكنهم مساعدتي في معرفة مكان خدمة توفيق. وبالفعل تمكنت من الحديث مع قائد مجموعته في الوحدة التي يخدم فيها، الذي أخبرني بأن توفيق أصيب منذ يومين في إحدى المعارك العنيفة التي دارت على تخوم دمشق، وأنه الآن في المشفى قيد العلاج.
ذهبت إلى المشفى لأسأل عنه، فأخبرني مديرها أنه الآن في غرفة العناية المشددة، بعد أن أجري له منذ يومين عمل جراحي، استُئْصلت فيه رصاصتان من صدره، وأنه الآن فاقد الوعي تماماً ولا يمكنني الحديث إليه أبداً.
آلمني جداً ما حصل لتوفيق، وأخذت أعد “السيناريوهات” المحتملة في كيفية إخبار أمه بما أصابه.
وفي صباح اليوم التالي ذهبت من جديد إلى المشفى لأطمئن عليه. دخلت غرفة العناية المشددة، لكن سريره كان خاوياً. هرعت ملهوفاً إلى رئيس القسم أسأل عنه فقال لي برأس مطأطئ : يسلم رأسك، المجند توفيق في أمان الله، غادرنا إلى ربه شهيداً للحق والوطن. اقشعر جسمي، وأنهمر دمعي فور سماع ذلك الخبر الصاعق، فلقد أحسست به وكأنه ابن لي، إنما ابن مولود من رحم الشقاء والعذاب. بكيت وبكيت وبكيت، نعم بكيت على حال وطن يمزقه الغزاة الأشرار، وعلى حال عائلة فقيرة معدمة فقدت معيلها الوحيد، فمن لها من بعده غير الله؟ مسحت دموعي وعدت لأسأل نفسي، ماذا عساي أن أفعل الآن؟، وكيف لي أن أتصرف؟ طلبت من رئيس القسم أن أرى توفيق، أن أودعه للمرة الأخيرة قبل أن يوارى الثرى، فأخذني إلى غرفة التبريد، ثم سحب الغطاء عن وجهه الطاهر، وتركني معه أناجيه. نظرت إلى الشهيد بعين دامعة، ثم ضممته إلى صدري كما سبق وأن ضمني أبي حين غادرت البيت إلى حلب لألتحق بدورة الجيش. عانقته مع أنني لا أعرفه، ولم يسبق لي أن التقيته قط. قبلته من جبينه، ثم قبلت يديه وكأنني أقبل ابني الذي ربيت، ثم رحت أحاوره. قلت له: حبيبي توفيق، أمك تقرئك السلام، وتقول لك: إنها في انتظارك، وأن الأولاد وزوجتك، وهي، جميعاً بخير. وتقول لك ألا تشغل بالك بمصروف العائلة، فلديها ما يكفي. وهي ما زالت عند عهدها لك، بأنها لن تستدين مالاً من أحد. لن تستدين حتى لو مات أهل بيتها جميعاً من الجوع، فكرامتك يا توفيق هي أعز ما تملك.
وبينما أنا أحاوره، لمحت طرف ورقة بيضاء بانت على جيب سترته. سحبتها فإذا هي مضرجة ببضع قطرات من دمه. فتحتها ببطء، خشية أن تتمزق نتيجة التصاقها ببعض. أفلحت في فتحها، فإذا هي رسالة كان قد كتبها إلى أمه. يقول توفيق: “أمي الحبييبة، يا أغلى الناس، أنا هلّق ع الجبهة، والضرب حوالينا على أبو جنب، وما بعرف إذا الله كاتبلي أرجع وشوفك، بعتلك هالرسالة مع رفيقي، يلي لح ينزل بكرا ع الشام، ليتعالج بعد ما صابوه هالملاعين بإجرو، الله يشفيه ويعافيه، بس مو هلّق إذا قرأتيها تبلْشي تبكي، لا تخافي علي يا أمي، أنا ما فيني شي، وكمان يلي الله كاتبو بدو يصير. أمي، يا حنونتي، في إلي مع رفيقي سليمان مية وخمسين ألف ليرة، حاططهم عندو لوقت العازة، إذا تأخرت بالرجعة لعندكم خديهم من عندو، الله يخليكي بدي وصيكي تشتريلو لأخي عماد بوط الأديداس من المحل يلي براس الحارة، وتشتري كمان شنتاية المدرسة يلي عليها صورة البوكيمون لأخي الفصعون تحسين، حاكم هلكني وهو عم يطلبها مني، وأنا ما كنت أحسن جبلو ياها، وكمان بدي ياكي تعطي لمرتي عشرين ألف ليرة، طلبتهن مني مشان أمها، حاكم أمها عايفة حالها، وبدها تدفع أجرة البيت وما معها ولا نكلة. أما انتي يا ست الحبايب، بتتذكري لما رحتي لعند جارتنا أم هيثم؟، وقلتيلي وقتها ما شالله حولها هالأم هيثم!، صاير عندها موبايل جخة!، والله يا نور عيوني أنا اشتريتلك أخوه بالزبط، روحي خديه من عند عبّودة، يلي بتم الحارة، بياع الموبايلات، بس عطيه ألفين ليرة كمالة حقو، انشالله بتتهني فيه، وقوليلو كمان خليه ينزلّك عليه أغاني فريد الأطرش يلي بتحبيهم، بس استني عليّ، لسا أنا محضرلك على عيد الأم مفاجأة بتاخد العقل، احزري شو محضرلك؟، ولا قلّك، بلا ما قول، لح اتركلك ياها مفاجأة، والله يا أمي لو تطلبي مني روحي لأعطيكي ياها، أحلى عيدية، وكمان بدي ياكي ما تنسي تغدي رفيقي شي غدا ظريف، الله يخليكي، حاكم هادا ياحرام واحد معتر، وميت فقر مثلنا، وصفيان جلدة وعضمة، بعرفك ما بتقصري، بس حبيت زكرك، وهلّق خاطرك ياست الحناين، ادعيلي أقدر أجي شوفك على عيد الأم”.
لم أتمالك نفسي بعد أن قرأت تلك الرسالة المتخمة بالحنان والروعة والرقة، فصرت أبكي بكاء مراً إلى أن ابتلت ياقتي بالدمع. عدت فقبلت الشهيد من جبينه مودعاً، ثم خرجت من المشفى هائماً على وجهي، لا أعي طريقي.
مشيت ومشيت، جبت الأزقة والحواري، صرت أرى وجه توفيق يشع في كل مكان، على واجهات المحال، على زجاج السيارات، في عيون الأطفال، على ضوء القمر الذي بدا يتلألأ على أسطح البيوت.
توقفت بعد ذلك مستنداً إلى جذع شجرة عند أول حارتنا، أخذت أفكر ماذا أفعل؟ عصرت ذهني عصراً، إلى أن قررت أخيراً أن أتصل بأم توفيق، وأخبرها بما حصل، مهما كانت العواقب. اتصلت بها على الفور، فقالت لي: من أنت؟ قلت لها: أنا الذي زرتني منذ فترة تسألينني عن ابنك توفيق. قالت: والله إني لا أتذكرك، والحقيقة أنني زرت مئات البيوت، وسألت عن ابني كل الناس، لكنني لم أعد أتذكر أحداً ممن زرتهم. قلت لها: لا يهم، فإن لدي رسالة من ابنك توفيق أريد إيصالها إليك. غصت الحروف في حلقها، وصارت تتلكأ في الكلام وكأنها تهجّي حروف اسمه، إلى أن أصبحت غير قادرة على الكلام. صرت أناديها: أم توفيق!!، أم توفيق!!، لكنها عبثاً لم تجب. أقفلت الخط، ثم أعدت الاتصال بها مرة ثانية وثالثة ورابعة، إلا أن هاتفها انطفأت حرارته، لسبب ما. أعدت الكرّة مساءً، ثم صباح اليوم التالي، لكن لا أثر لأم توفيق، وكأن مصاباً ما قد ألم بها عندما سمعت برسالة ابنها، فهل هو الإغماء؟، أم هو الموت؟، الله أعلم. ذهبت إلى المشفى، فلعل إدارته قد أخبرت أهله بشيء ما، فأرى هناك أحداً منهم لأعطيه الأمانتين: الرسالة، والنقود. وصلت المشفى فرأيت على الباب نعش الشهيد محمولاً على أكتاف مجموعة من الجنود يدخلونه إلى سيارة الإسعاف، وهم يكبرون ويهللون، تمهيداً لمواراته الثرى في مقبرة الشهداء. نظرت في جميع الوجوه الموجودة في المكان، لكن لا أثر لأحد من أهله، حيث خلت بوابة المشفى إلا من بعض نسوة، كن جالسات على المقاعد الخارجية للمشفى، اللواتي أخذن يزغردن احتفاءً بالعريس الشهيد. سرت بعد ذلك مرافقاً الجموع إلى مقبرة الشهداء لعلي أحظى هناك بأحد من معارفه ينتظر عند المقبرة، لكن كذلك، لم يكن هناك أي قريب أو صديق للشهيد. باشر الجنود بفتح القبر، ثم سجوا الجثمان فيه. وقبل أن يرموا التراب عليه نظرت إلى الشهيد نظرة أخيرة مودعاً، ثم قلت له بصوت عال أمام الجميع: توفيق!!، أعتذر منك أيها الغالي!!، سامحني أنني لم أستطع أن أجد أمك لأوصل لها رسالتك!!، ها هي رسالتك، خذها معك، وسلمها بيدك، فلربما تلتقيان معاً عند أبواب الجنة، لقد ضاعت أمك عني، أو لعلها في الطريق إليك، لكنني أتيت إليك هنا لأعاهدك أمام الله، عهد الحق، بأنني سأبحث عن عائلتك ما حييت، وسأكون لهم كما لو أنك معهم.
رميت بالرسالة إلى القبر، وقرأت الفاتحة على روحه الطاهرة، ثم ودعته قائلاً له: في أمان الله يا توفيق!!، في أمان الله أيها الوطن!!