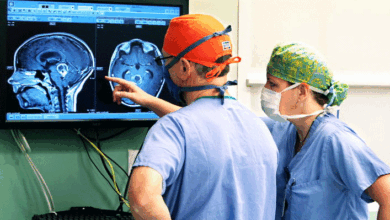د . عقيل سعيد محفوض – في الكتابة عن سورية : تفكيك غموض ثقيل !
|| Midline-news || – الوسط ..
كانت سورية -حتى وقت قريب-من الدول الأقل تناولاً في الكتابة السياسية والأكاديمية في المنطقة، وكادت “تغيب” حتى عن الكتابات التي تتناول موضوعات لصيقة بها، مثل: لبنان، وفلسطين، و”إسرائيل”. وثمة دراسات وبحوث حول المنطقة، بالكاد تذكر اسمها. لا ننس أن “المكتبجي”، كان بالمرصاد لمنع أي دراسة يقرأ فيها انتقاداً لسلطته، أو: مساً بإيديولوجياته الرسمية وغير الرسمية. وفي هذا مُكابدة يُدركُها كلّ من يريد البحث أو الكتابة في السياسة السورية !
لماذا “غابت” سورية عن الكتابة السياسية، ولماذا بدت صورتُها – في حال تم ذكرها أو تناولها – “باهتة” و”هامشية” و”مُجهدة”، ولماذا لا يجد القارئ دراسة أكاديمية واحدة معتبرة عن الجولان السوري المحتل، أو: لواء اسكندرون، أو حرب حزيران/يونيو 1976، أو حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، أو: أزمة الثمانينيات مثلاً، أو: التكوين الاجتماعي والإثني والثقافي والسياسي، أو: المسألة الكردية، أو: المسألة الدينية، أو: السياسة الخارجية، مثل العلاقة مع إيران، أو: حزب الله، أو: السعودية، وغير هذا كثير؟
أموات وشتات ..
بدت سورية، كما لو أن أهل العلم والثقافة فيها قد “هجروها”، ولم يهتموا بالحديث أو الكتابة عنها، وبقي الخطاب السياسي والثقافي بعيداً عن طرح الأسئلة اللازمة بهذا الخصوص، ربما لم يلحظ الأمر، أو أنه لم يهتم له، لأن الأولوية كانت طوال عقودٍ عدّة -وهذه ملاحظة تقديرية ليس يقينية- لإيديولوجيات وسياسات نمطية، كشفت الأزمة عن أنها مجرد شعارات بلا معنى تقريباً، أو: أنها ضعيفة الأداء، أو: منتهية الصلاحية.
لماذا لم يُنتج السوريون إلى حدّ الآن كتاباتٍ في العلوم الاجتماعية، تتجاوز كتاب “القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي” لـ عبد الرحمن الشهبندر الذي صدر في دمشق عام 1932/1933، أو مشروعاً معرفياً سياسياً من وزن ما أنتجه زكي الأرسوزي وأنطون سعادة، وبعد ذلك ياسين الحافظ، والياس مرقص، أو في المسرح مثل: سعد الله ونوس، ومحمد الماغوط من الأموات؛ أو: من وزن المشروع الإبداعي لـ أدونيس، من الأحياء في الشتات، ومثل ذلك كثير.
افتتان ..
أظهر السوريون افتتاناً كبيراً بعدد من الكتاب الذين تناولوا بلدهم وشؤونهم، باتريك سيل مثلاً، له كتابان عن سورية هما “الصراع على سورية” و”حافظ الأسد: الصراع على الشرق الأوسط”، تلقاهما السوريون باهتمام كبير، وقد أصبحا مرجعين معتمدين لديهم -ولدى غيرهم- في الشأن السوري. وهناك كتاب آخرون، مثل: اللبناني كمال ديب الذي كتب بغزارة عن سورية، وأنتج عدداً من الكتب الجيدة منذ بداية الأزمة السورية وحتى الآن، والفرنسي فيليب خوري الذي كتب عن أعيان دمشق، وسورية والانتداب الفرنسي، والفلسطيني حنا بطاطو صاحب كتاب “فلاحو سورية”، الأقل شأناً بين كتبه، والإسرائيلي إيال زيسر، وغيرهم.
ومن المناسب الإشارة إلى الكاتب والإعلامي اللبناني سامي كليب الذي قدم أحد أهم الكتب التي تناولت الحدث السوري، أعني كتاب “الأسد بين الرحيل والتدمير الممنهج: الحرب السورية بالوثائق السرية” الذي تضمّن نصوصاً ووثائق ومحاضر جلسات تنشر لأول مرة، وأضاء على لحظات غامضة نسبياً في تاريخ التفاعلات السورية-الأمريكية خلال وبعد الحرب الأمريكية على العراق عام 2003، وقد طُبع الكتاب مراراً في بيروت والجزائر، وكان من أكثر الكتب مبيعاً. ومن الواضح أن الإعلامي كليب حصل بفضل أدائه ومكانته وحضوره المتميز، على فرصة نادرة للحصول على محاضر جلسات رئاسية، من غير المعتاد أن تكون متاحة للباحثين في بلد، مثل: سورية!
شغف رسمي ..
أظهرت المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية “شغفاً” منقطع النظير بعدد من الكتّاب والمُعلّقين والمحللين والإعلاميين والفنانين العرب وإلى حد ما الأوربيين، بوصفهم خبراء وأعلاماً يمكنهم أن يكتبوا عن سورية، ويحدِّثوا السوريين عن بلدهم وعن أنفسهم، بدءاً من الحرب والسياسة إلى الإعلام، وصولاً إلى الأبراج وقراءة الطالع. وقد أقامت إحدى الجهات الرسمية حفلاً تكريمياً للفنان الراحل ملحم بركات، وهو يستحق التكريم، ولكنها لم تجد الوقت أو الهمة أو الاهتمام الكافي لعقد مؤتمر على مستوى وطني لمناقشة الجانب الثقافي للحرب الدائرة، أقصد المصادر الثقافية للحرب، والمخارج الثقافية للحرب أيضاً، وهذا أضعف الإيمان، وإذا لم تقتنع بوجود سوريين قادرين على فهم ما يجري والكتابة عنه، فلديها قائمة كبيرة من المتحدثين من غير السوريين للحديث في الموضوع.
تبدو الأمور كما لو أن الكتابة عن سورية وحتى الغناء لها هما: “شأن الآخرين”، على أهمية ما قام به عدد من الكتاب والإعلاميين والفنانين وغيرهم في هذا الباب، ذلك أن العديد منهم قدّم جهداً صادقاً، وعمل بدأب، من أجل مساعدة السوريين على فهم ما يجري، وحتى مجرد إمتاعهم وتزجية الوقت أمام الشاشات، أو: في الصالات، والمدرجات.
بالمقابل، انشغل السوريون – وفي هذا شيء من التعميم المتسرع نسبياً-بالكتابة عن الهجرات من شبه الجزيرة العربية، والحيوان في الشعر الجاهلي، والاستعمار، والعولمة، والنظام العالمي الجديد، وصدام الحضارات، والاستشعار عن بعد، والمهن اليدوية، وسكاكين المطبخ العربي الإسلامي، والفتح العثماني، وفتح العرب لأمريكا، والرسالة الخالدة للأمة العربية …
قصة حب سلجوقية..
الطريف أن وزارة الثقافة والإرشاد كلفت أحد الروائيين بالإشراف على إصدار سلسلة ثقافية، وكان جُلّ ما نشره فيها الكتب التي تمجد الحقبتين المملوكية والعثمانية، وقيل: إن هيئة الكتاب –وهي مؤسسة حكومية-نشرت كتباً تدعو للتعصب والكراهية، وتضمنت إساءات صريحة لمكونات دينية ومذهبية سورية ومشرقية، ربما من أجل أن تثبت لروائي دمشقي أن النقد المسموح به للدين لا يقتصر على “الإسلام السني” كما ادعى، بعد انشقاقه طبعاً.
انشقاق ..
الطريف أيضاً أن عدداً من “المثقفين” المدللين، والمخصصين (أو المُؤمَّلين) بمكاسب ومكافآت منظورة وغير منظورة، انشق لاحقاً، وكان الروائي المشار إليه واحداً منهم، وهكذا مثلاً انتقل كاتب ومعد برامج في التلفزيون الرسمي من الكتابة عن الوحدة الوطنية إلى الكتابة عما سماه “خرافة الهولوكوست العلوي”، ودعا كاتب آخر -كان عمل قبل انشقاقه مستشاراً لدى إحدى المؤسسات الأمنية- إلى عمليات إبادة طائفية مذهبية، متحدثاً بوقاحة داعشية عن “انقراض مذاهب” معينة في سورية، والأهم هو ما وصل إليه كاتب جامعي يساري معروف بنقده للاستشراق (وبعلاقاته مع المؤسسة الأمنية) بالانتقال من “نقد الفكر الديني” والدفاع عن سلمان رشدي إلى ترويج خطاب طائفي “وهابي” تحت اسم: “الثورة”.
اعرف عدوك ! ..
المفارقة أن الإسرائيليين كانوا أكثر اهتماماً بالكتابة عن سورية، وتمثل مراكز البحوث الإسرائيلية عيناً فاحصة ومُدققة على الشأن السوري، وتنتج دراسات وتقديرات مستمرة للرأي العام وصناع القرار هناك. ويصدر في فلسطين المحتلة في كل عام تقريباً دراسات تتناول حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 مثلاً، ولكن السوريين لم يبادلوا الإسرائيليين بالمثل، بمعنى أنهم لم يهتموا كثيراً بالكتابة عن “إسرائيل”، ولا عن حروبهم معها، ولا عن تحدياتها وتحولاتها، وقد لا تكون لدى الكثيرين منهم معلومات جدية عنها، ولو من باب “اعرف عدوك”.
علينا أن نستدرك هنا، ذلك أن إسرائيل من منظور العديد من المثقفين لم تعد عدواً بل أصبحت حليفاً، ولا يخفى على متابعي الحدث السوري رعاية إسرائيل –بالتعاون مع تركيا والسعودية والأردن، أو بشكل منفصل-لجانب كبير من المشهد السياسي والعسكري المعارض في سورية.
غموض ثقيل وسيولة ملغزة ..
نتحدث عن “غموض ثقيل” في باب الكتابة السياسية، لأنه يلقي بظلاله على صورة سورية ومعناها وفكرتها ودورها ووزنها الخ، وقد تحولت سورية منذ آذار/مارس 2011، وبفعل ارتفاع الطلب على الكتابة عنها، إلى ظاهرة رقمية أو ميديائية، بل أصبحت الكتابة عنها ظاهرة ريعية بامتياز، ويعلم المتابعون كيف عملت دول وفواعل عديدة على تمويل عمليات “انشقاق” ثقافية وإعلامية وغيرها.
من عوامل الغموضِ الثقيلِ المشار إليه، تجد عمليات “التطفيش” الممنهج التي اتبعتها –بشكل قصدي، أو: بحكم طبيعتها!- مؤسسات وفواعل ثقافية وإعلامية وسياسية لمثقفين كُثرٍ ليبحثوا عن حيز للكتابة والعمل لدى منابر في الخارج. وعندما وقعت الواقعة كانت فواعل متعددة من الثقافة والإعلام خارج البلد، وخرجت معها شريحة كبيرة أيضاً تحت ضغوط الأزمة، أو تأثير الضغوط المخيالية التي دفعت شريحة أخرى للحصول على الأمن أو الريع!
ومع النزيف المتزايد في الرأسمال البشري، وخاصة المشتغلين في الثقافة والإعلام، كانت القدرة على مقاومة الحرب أقل من المفترض. وهكذا فقد أصبح السوريون مثقلين بصور ومدارك نمطية سلبية فائقة، هي شكل من أشكال الحرب متعددة الأشكال ضدهم، ويجد كثير منهم صعوبة في مقاومة طغيان الصور المقولبة والأدلجة الفائقة لكل ما يتعلق بهم.
ثقافة آمنة .. وهامسة ..
بعض المشتغلين بالكتابة والشأن الثقافي “فضَّل” العمل في موضوعات وقضايا “آمنة” أو “مُجدية” مادياً ومعنوياً، مثل الرواية والشعر والدراما والفن، ويجب تقدير إنجازاتهم في هذا الباب، ولكن تلك الإنجازات أو الفتوح، على أهميتها، إلا أنها ربما تكشف -في جانب منها-عن “استقالة” غير معلنة من تناول الشأن العام، بالكيفية التي يجب تناوله فيها.
وحدث أيضاً “تحوّل” من العلنية والمباشرة في الانهمام بالشأن العام إلى “الهمس” من وراء ظهر السياسي وداخل الأبواب المغلقة. وربما تحول البعض –وليس لدي معلومات كثيرة عن هذه النقطة بالذات-من الكتابة العلمية والثقافية إلى “المذكرات” و”التقارير” و”الوشايات”.
تنكيت وتبكيت ..
الظاهرة المذكورة لا تُفَسَّرُ بالسياسة وحدها، ولو أن السياسة هي المتهم الرئيس هنا، إذ ثمة نوع من الاغتراب الحاد، المَرَضِيّ أحياناً، يحيل إلى شعورٍ عميق بالإحباط وفقدان الوزن والمعنى، وهذا أمر تطوري أو تراكمي، ولم يحدث بين يوم وليلة. وعندما يعزف الناس عن السياسة ويصبح الاهتمام بالشأن العام مادةً أو مناسبةً لـ “التنكيت” أو “التبكيت”، فهذا يعني أن الأمور تتجه للاصطدام بالجدار، أو: ربما السقوط في الهاوية. وهو ما يبدو أنه حدث بالفعل!
كتابة الأمل ..
لعلَّ ما تشهده سورية اليوم، يمثل مناسبة، قل فرصة، لـ “حلحلة” و”تفكيك” تلك العوامل والفواعل التي أدت إلى ذلك “الإجهاد الثقافي” و”الغموض الثقيل” ثم “السيولة الملغزة” أو “المريبة” في صورة سورية وفي مدارك أهلها عنها وعن أنفسهم. إذ “تُفصح” سورية اليوم عن “حقيقتها الحقيقة” وليس “الافتراضية” أو “الموهومة”، بأكثر مما فعلت طوال تاريخها المعاصر، كما لو أن الكتابة عنها اليوم، هي “كتابة الكارثة”، وفق تعبير مستعار من موريس بلانشو.