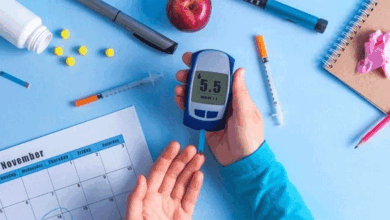خلوة فكرية مع الفُتوحات المكّية .. نجيب البكوشي ..

الفُتوحات المكّية ..
لولا نفسُ الرحمن،
ما ظهرت الأعيانُ
ولولا قُبولُ الأعيان،
ما اتصفت بالكيانِ ، ولا كانَ ما كانَ
الصبحُ إذا تنفّسَ،
أذهب الليل الذي كان عسعسَ
فلولا الليلُ ماكان النهارُ
ولولا النورُ ما وُجد النِّفارُ
ولولا الصّيدُ ما نفرَ الغزالُ
ولولا الصَّدُّ ما عَذُبَ الوِصاَلُ
ولولا الشّرعُ ما ظهرت قيودٌ
ولولا الفِطرُ ما اُرْتُقِبَ الهلالُ
ولولا الكونُ ما انفطرتْ سماءٌ
ولولا العينُ ما دُكَّتْ جِبالُ
ولولا ما أبان الرُّشدُ غيّاً
لما عُرِفَتْ هِدايةٌ أو ضَلالُ
ولا كان النّعيمُ بكلّ شيءٍ
ولا حُكْمُ الجلَالِ ولا الجمَالِ
أرى شخصا له بصَرٌ حديدٌ
له الأمرُ المُطاعُ له النِّزالُ
وآخرٌ ما له بصرٌ ويَرْمِي
ولا قوسٌ لديه ولا نِبالُ
فسبحان العليمُ بكلّ أمرٍ
له العلمُ المحيطُ له الجَلالُ
إذا نَظَرَتْ إليه عيونُ قومٍ
بلا جفنٍ بدا لهم الكمالُ
فوقتا لا يروْنَ سوى نفوسٍ
مُبَعَّدَةٍ وغايتُها اتّصالُ…
الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي ..
بعد سنة ونيف من خلوة فكرية ممتعة مع كتاب الفتوحات المكية للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، أوّل انطباع رسخ في ذهني، بعد أن انهيت قراءة هذا الأثر في طبعته الصادرة في تسعة مجلدات عن دار الكتب العلمية ببيروت سنة 1999، أن الفتوحات المكيّة ليس كتابا فحسب، بل هوّ دائرة معارف كبرى، ومعلم صوفي وأدبي وفلسفي وإنساني عظيم. وتذكّرت وصف شاعر ألمانيا الكبير يوهان غوته للأثر الفكري لإبن عربي عندما قال:” إنه بوابة الإسلام الموشَّاة بسجوف الحكمة والحبِّ».
استغرق ابن عربي في كتابة الفتوحات المكية حوالي أربعة عقود من الزمن، بين سنتي 598 -636 هـ، وكتبه مرّتين، ويتكون الكتاب من سبعة وثلاثين سِفرا في نسخته القونويّة نسبة إلى تلميذه وربيبه صدر الدين القونوي، ويحتوي كل سِفر على نحو ثلاث مائة صفحة.
يتحدّث ابن عربي عن كتابه الفتوحات المكية الذي يُعتبر ذروة الفكر الأكبري فيقول : “كتاب كبير في مجلدات مما فُتح به عليَّ في مكة، يحتوي على 560 بابًا في أسرار عظيمة من مراتب العلوم والمعارف والسلوك والمنازل والمنازلات والأقطاب.”
يؤكّد ابن عربي ان كل ماكتبه هي فتوحات ربانية من السماء، ويقول “ما قصدت في كل ما ألفته مقصد المؤلفين ولا التأليف، وإنما كان يرد عليَّ من الحق موارد تكاد تَحرِقُني، فكنت أتشاغل عنها بتقييد ما يُمكن منها، فخَرَجَت مَخرجَ التأليف، لا من حيث القصد، ومنها ما ألَّفته عن أمرٍ إلهي أمرني به الحق في نومٍ أو مكاشفةٍ.” ويضيف في باب معرفة الكاتب وصفاته وكتبه، الأبيات الشعرية التالية:
قلمي ولوحي في الوجودِ يَمُدُّه قـلمُ الإلهِ ولوحُـهُ المـحـفوظُ .
ويَـدِي يـمينُ الله في ملكوتِه .
ما شئتُ أجري والرسومُ حظوظُ …
لا نستطيع فهم هذه الأبيات المُوغلة في الرمزية إلاّ اذا كان لنا علم بالتقسيم الأكبري للعلوم.
يقسّم ابن عربي في مقدمة كتابه العلوم إلى ثلاثة أقسام:
- علوم العقل: وهي العلوم التي تحصل نتيجة النظر والتدبُّر ومنها الصحيح ومنها الفاسد مثل الفلسفة وعلم الكلام والطب والفلك والرياضيات.
- علوم الأحوال: وهي مجموعة العلوم التي لا سبيل إليها إلاّ بالذوق، فلا يستطيع عاقل ان يَحُدَّها أو يُقيم على معرفتها دليلا، كالعلم بحلاوة العسل ومرارة الصبر ولذة الجماع والعشق والوجد والشوق وما شاكل هذا النوع من العلوم.
- علوم الأسرار: وهي علوم فوق طور العقل، ويختص بها فقط الأنبياءُ والأولياء وهي علوم لدُنيّة.
يقتدي الولي الصوفي بتجربة النبوّة ويجعل مصدره الأساسي في المعرفة هو الوجدان، ومجال بحثه علوم الأحوال وعلوم الأسرار، في حين سيجعل الفقيه مصدره الأساسي للمعرفة هو النقل من خلال آليات استنباط معرفي أهمها الإجماع والقياس. لذلك يقول أبو يزيد البسطامي احد اعلام التصوّف مخاطبا الفقهاء : أخذتم علمكم ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت.
هذا القول لأبي يزيد البسطامي يحيلنا على فكرة مركزية داخل التصوّف عموما وفي الفكر الأكبري على وجه الخصوص وهي فكرة الولي. منذ نشأة التصوّف سيثور جدل حاد بين الصوفية والفقهاء حول مقام الولي وعلاقة النبوّة بالولاية، ولسبر أغوار فكرة الولاية عند ابن عربي سنعتمد على كتاب هام للمفكّر الفرنسي؛ ميشيل شودكيفِتش يحمل عنوان خاتم الأولياء: النبوة والولاية في مذهب ابن عربي.
توجد ترجمة عربية ممتازة لهذا الكتاب أنجزها شيخ الأزهر أحمد الطيّب عن الأصل الفرنسي وعن الترجمة الإنجليزية معا.
المفكّر ميشيل شودكيفيتش هو أيضا مترجم كتاب الفتوحات المكيّة إلى الفرنسية، بعد وفاته سيترك المشعل في مجال دراسة الفكر الأكبري لإبنته كلود آداس التي كانت قد أصدرت كتابا حمل عنوان ” ابن عربي أو البحث عن الكبريت الأحمر”، وهو من الكتب التي اعتمدتها في هذا البحث.
نعود إلى علاقة الولاية بالنبوّة في فكر محيي الدين بن عربي من خلال كتاب ميشيل شودكيفِتش:
يبدأ شودكيفيتش بتحديد المعني اللغوي لمصطلح الولي.
الولي لغة هو القريب والنصير والحليف، وهو كذلك الحاكم والمدبّر والقائم بالأمر وقد وردت كلمة “ولي” في القرآن تحت اشتقاقات متنوعة مائتين وسبع وعشرين مرّة.
الشيعة هم اوّل من جعل لمفهوم الولاية مضمونا سياسيا ودينيا، فأصبحت الولاية معهم ميراثا نبويا انتقل من النبي محمّد إلى علي بن أبي طالب ومنه إلى خلفه من آل البيت، فالولي/ الإمام هو امتداد للنبي. التصوّف الذي نشأ مع التشيّع في نفس البيئة الفكرية في العراق وبلاد فارس سيأخذ عنه فكرة الولي ولكنّه سيسمو بها في معارج الروح بعيدا عن الاستقطاب المذهبي و السياسي.
عند أهل التصوّف “الولي” هو اسم مشترك بين الله وبين الإنسان: فـ”الولي” هو أحد أسماء الله الحسنى ؛ وهو أيضًا اسم يُطلَق على الإنسان، ورد في النص القرآني: “الله ولي المؤمنين”، سورة آل عمران الآية (68)، “الله ولي الذين آمنوا يُخرِجهم من الظلمات إلى النور”، سورة البقرة الآية (257)، “ألا إن أولياء الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون”، سورة يونس الآية (62).
حول الولاية والنبوّة والرسالة يذكر ابن عربي في الفتوحات المكية ما يلي: “ثبت أن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم قال إن الرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي و لا نبي، الحديث بكماله، فهذا الحديث من أشد ما جَرَعَت الأولياء مرارته فإنه قاطع للوصلة بين الإنسان و بين عبوديته و إذا انقطعت الوصلة بين الإنسان و بين عبوديته من أكمل الوجوه انقطعت الوصلة بين الإنسان و بين اللّٰه فإن العبد على قدر ما يخرج به عن عبوديته ينقصه من تقريبه من سيده لأنه يزاحمه في أسمائه و أقل المزاحمة الاسمية فأبقى علينا اسم الولي و هو من أسمائه سبحانه… ”
الأولياء عند ابن عربي هم ورثة الأنبياء وهمزة الوصل بين الأرض والسماء، بين العبودية والأولوهية.
أمّا السبيل إلى” الولاية” فهو مجاهدة شهوات النفس والتقرّب من الله، حيث يتدرّج الصوفي في معراجه الروحي في مقامات القرب من الله، والمقام عند أهل التصوّف هو مقام العبد بين يدي الله، وأوّل المقامات؛ هو مقام التوبة، ثم يليه مقام الصبر، ثم مقام الشكر، ثم مقام الرجاء، ثم مقام الخوف، ثم مقام الرضا، ثم مقام الزهد، ثم مقام الفقر، ثم مقام الورع ويضيف ابن عربي مقام القُربة… و المقامات في التصوّف مرتبطة بالأحوال، والحال كما يعرّفه أهل التصوّف هو نازلة تنزل بقلب العابد ولكنّها لا تدوم، والفرق بين المقام والحال هو أن المقام يكتسبه المتصوّف عن طريق المجاهدة والعبادة، أما الحال فهو فيض من الله، والأحوال كذلك درجات وانواع مثل حال المراقبة، وحال القرب، وحال الحب، وحال الشوق، وحال الأنس، وحال الطمأنينة وحال اليقين…
تتحدّد مرتبة الولي من خلال درجة قربه من الله فمن الأولياء من يمكث في درجة المحادثة، ويسمّون أهل الحديث، ومنهم من يمكث في درجة المجالسة، وهم أهل المناجاة، أمّا أعلى درجات القرب من الله فهي درجة المشاهدة وهي درجة الفناء في عين الألوهية كما يسمّيها ابن عربي.
اهمّ صفات الولاية عند ابن عربي هي العلم الباطن، فالولي عنده هو العارف بالله، والولاية عند ابن عربي تشمل كذلك الأنبياء والرسل. فالرسل و الأنبياء هم كذلك لأنهم يحملون رسالة للبشر وهم أولياء من حيث علمهم بالغيب.
نظرية الولاية عند ابن عربي، وفكرة وجود الولي في حياة المؤمن بعد ختم النبوّة ستثير حفيظة الفقهاء تجاهه، وسيُتّهم بانه جعل مرتبة الاولياء أعلى من مرتبة الأنبياء. الحقيقة ان ابن عربي قال ان كل كل نبي او رسول هو ولي، وصفة الولي أفضل في ذات النبي أو الرسول من صفتي النبي أو الرسول لأن الولاية دائمة وتتعلق بالدنيا والآخرة في حين ان الرسالة والنبوة محدودتتين وتنتهيان بانتهاء التكليف. اذا ابن عربي لم يفاضل بين الولاية والنبوة والرسالة في المطلق بل فاضل بينها من حيث انها ثلاث صفات تعود على شخص النبي أو الرسول.
أورد الكاتب المصري الدكتور أبو العلا عفيفي في كتابه التصوّف: الثورة الروحية في الإسلام، في الصفحة 264 شهادة للفقيه والزاهد عبد الوهاب الشعراني من كتابه اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر يُفنّد فيه فكرة ان ابن عربي قال بأفضلية الولي على النبي أو الرسول في المطلق حيث يقول: “ان الشيخ، يعني ابن عربي، لم يقل ان الولي افضل من الرسول او النبي، وانما قال،” اختلف الناس في رسالة النبي وولايته أيهما أفضل، والذي أقول به إن ولايته أفضل للشرف المتعلق بدوامها في الدنيا والآخرة، بخلاف الرسالة فإنها تتعلق بالخلق، وتنقضي بانقضاء التكليف”.
ثمّ كيف لابن عربي ان يقول بأفضلية الولي على النبي والرسول في المطلق وهو القائل ان هذه الولاية منبعها” الروح المحمدي” نسبة إلى الرسول محمّد، وهو منبع العلم الباطن لجميع الأنبياء و الأولياء بمن فيهم ابن عربي؟
كان ابن عربي على وعي بخطورة التأويل الخاطئ لأفكاره خاصّة من عامة الناس، فلجأ إلى لغة رمزية على غاية من التعقيد، وقال: «أنا لغز ربي ورمزه، ومن عرف أشعار الألغاز عرف ما أردناه»، لذلك فصل بين ثلاثة أنواع من العقائد: عقيدة العوام وعقيدة الخواص وعقيدة الخلاصة. يقول ابن عربى في كتابه الفتوحات المكية بعد ان ذكر عقيدة العوام وعقيدة الخواص:” وأمّا التصريح بعقيدة الخلاصة، فما أفردتها على التعيين لما فيها من الغموض، لكن جئت بها مبددة في أبواب هذا الكتاب مستوفاة مبينة، لكنها كما ذكرنا متفرقة. فمن رزقه الله الفهم فيها يعرف أمرها ويميزها من غيرها، فإنها العلم الحق والقول الصدق، وليس وراءها مرمى. ويستوي فيها البصير والأعمى، تُلْحِقُ الأباعد بالأداني، وتُلْحِمُ الأسافل بالأعالي”.
الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي كان يخشى سوء فهم عامة الناس، وتحريض الفقهاء المعادين لعقيدة التصوّف ضدّه فعمد إلى تشتيت أفكاره وتلغيزها. يذكر في كتابه الفتوحات المكية هذه الأبيات لحفيد علي بن ابي طالب، عليّ بن الحسين زين العابدين والتي قال فيها:
يا رُبَّ جَوهَرِ عِلمٍ لَو أَبوحُ بِهِ
لِقيلَ لي أَنتَ مِمَّن يَعبدُ الوَثَنا
وَلَاِسَتَحَلَّ رِجالٌ مُسلِمونَ دَمي
يَرَونَ أَقبَحَ ما يَأتُونَهُ حَسَنا…
*نجيب البكوشي باحث وكاتب تونسي.
المراجع:
*الفُتوحات المكّية للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، دار الكتب العلمية ببيروت سنة 1999.
*خاتم الأولياء: النبوة والولاية في مذهب ابن عربي، ميشيل شودكيفيتش.
Michel Chodkiewicz, Le Sceau des saints : Prophétie et sainteté dans la doctrine d’Ibn ‘Arabī
Éditions Gallimard, Paris, 1986.
* ” ابن عربي أو البحث عن الكبريت الأحمر”، كلود آداس
Claude Addas, “Ibn Arabi, ou, La quête du souffre rouge”. Éditions Gallimard, Paris, 1989.
*التصوّف، الثورة الروحية في الإسلام، أبو العلا عفيفي، مؤسسة هنداوي للنشر، القاهرة 2017.