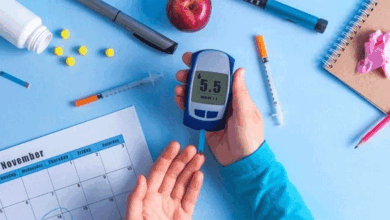الرواية والقصة العربية وعثرات نهضتنا .. تفيد أبو خير ..

الرواية والقصة العربية وعثرات نهضتنا ..
في المرحلة الإعدادية .. حين لم يكن هناك انترنت ولا جوالات، كنا نقرأ كل الروايات التي كُتب في ترويستها “روائع الأدب العالمي”.
ألف باء القصة لدينا كانت “ماجدولين” و”البؤساء” و”آلام فرتر” و”الشاعر” و”قصة مدينتين” وكل ما تعرفونه من روايات “أوروبا التاريخية”، كنا “أنا وغيري ممن عرفتهم يحبون القراءة” نتحاشى قليلاً الاقتراب من معطف غوغول، ومن شجاعة ديستويفسكي في سبر الذات ومكاشفتها في نزقها، وندرك صعوبة فهمنا لتولستوي، وأخيراً فإن يسارية مكسيم غوركي جبّت القراء عن الخلطة الروسية الأدبية العظيمة، لأن القفلة كانت تمهد لموقف يوحي بالتقرب من الشيوعية، التي أدت إلى تيارات أكثر نخبوية في مرادفاتها اليسارية، حسبما يصفها صديق قديم مهاجر باع ما يملكه في لبنان وصار في البرازيل.
وقعتُ على نجيب محفوظ في مكتبة المدرسة الثانوية، اختبرتني أمينة المكتبة التي شكّت بأني أعطي الروايات لأحد ما ليقرأها، لكثرة استعاراتي، فلخّصلتُ لها “الحرافيش”، فأعجبتها الفكرة وأصبحت تطلب مني أن أحكي لها كل قصة أنتهي منها، فحدثتُها عن “بين القصرين” و”قصر الشوق” و”السكرية”، و”خان الخليلي” و”أولاد حارتنا“، و”الشحاذ” و”حضرة المحترم” والجمل الرائعة عند محفوظ مثل : “وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، انت لسا بتفكر يا بني ؟؟” من “حب فوق هضبة الهرم”.
إلا أنني لم أستسغ الروايات الفرعونية لمحفوظ، لكنني أقول له اليوم عن بقية رواياته وعن لسان فتواته “عفارم يا بن الأصول”.
عندما كنت أقضي الليل لأنهي “العيب” و “الحرام” ليوسف إدريس في الثانوية العامة، ثم روايات مدن الملح لمنيف والرائعة موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح شعرت بالحنين إلى الأدب الأوروبي القديم .. نسبياً، أي أدب ما قبل التكنولوجيا، لأني كدت أن أقتنع أن وسائل التواصل ستجعل من الآداب ما يشبه أساطير الأولين.
فقرأنا بعد ذلك العطر وخضنا تجارب ستيفان زفايج، فعشنا أوروبا في مجساتها الشديدة الحساسية.
دخلنا كغيرنا في موجة أحلام مستغانمي، في لجة التسعينيات، وقلت حينها إنها حين تكتب، فإنها تقضي نهارها في مكتب غوستاف فلوبير، وتقيّل في جمهوريات الموز، حيث تنتشر حولها “نتاتيف” من قصص ماركيز.
لكن أمين معلوف كان أشبه بصقر يجوب الساحل الشرقي للبحر المتوسط.
أوشكت الرواية العربية على الوقوع في فخ ال”ألزهايمر” بسبب قوة السيطرة في بعض الدول العربية على المنشور والمقروء والأدب بكل وديانه وتلاله، وضاعت القصة، والشعر كذلك قبلها، وتضاءلت فرص النهضة بالآداب، لأن الوصاية الرسمية على المنشور كانت بذراعين فاليمنى كانت تحمل مقصاً لقص النص إن لحقت بكاتبه تهمة “يرعى قرب الحمى”، وإن فاق النص هذه المقولة ينتقل المقص من النص إلى لسان صاحبه، فإن فاقها انتقل المقص من اللسان إلى الرقبة.
أما الذراع الأخرى فكانت لإظهار كتاب وأدباء جدد .. وقد يكونوا جدداً في كل شيء، فتدعمهم السلطة أو جانب قد يكون هو الأقوى في السلطة، ويصبحوا أدباء كبار معروفين، وهذه الذراع صنعت ممثلين ومطربين وشعراء كثر، لذلك فإنك تتفاجأ بأن مكتبات بغداد والقاهرة ودمشق والقيراون والبصرة وحلب والقدس قبل ألف عام كان في كل منها مئات آلاف الكتب، وكان عدد السكان يومها أقل من خمس عددهم اليوم، واليوم يعايرنا الإحصاء الإلكتروني بأن العرب أقل الناس قراءة واقتناء للكتب ؟
لماذا ؟ سأقول لكم لماذا؟، لأن العربي لا يثق بكتاب قرأه واختاره له إنسان لا يعرفه، أو إنسان يحدد له آفاق وعيه السياسي وتفكيره ومحاكماته العقلية، أو رقيب لا يريد للإنسان العربي أن يطلع على أفكار أو مواقف وأحداث يحجبها عنه.
روايات وأعمال كثيرة صدرت في الشارع الثقافي العربي في القرن الجديد، وأصبحت الدعاية مرهونة برأي قارئ واحد، أحدهم قرأ عزازيل فعممها وتحدث بها، وآخر بحث مع عبد الكريم ناصيف عن نجم القطب فأخذ معه حملة واسعة من القراء.
بعد تفكك الاتحاد السوفييتي بسنوات، عادت الشهرة بقوة إلى الأدب الروسي القديم في شرائح كثيرة كانت قد تتردد في قراءته، وظهرت من جديد الجزالة والعبقرية فجلنا معهم شوارع بيترسبورغ وفتشنا خزائن آنا كورنينا وتتبعنا خطوات الأخوة كارامازوف في الثلج، وقامرنا مع ديستويفسكي في الليالي البيض.
ثم اشتعل الحنين من جديد ولكن لرواية عربية معاصرة ومستمرة .. كنت متوقعاً أن مستغانمي لن تكثر من كتابتها لأنها رصدت مرحلة التحولات وأقفلتها ولم تعطنا إشارة إلى نفق ستتخذ منه ممراً إلى أعمال جديدة “تنكش” فيه تطورات الوعي في الجزائر والمغرب العربي عامةً.
وربما فعلت في “غفلة من متابتعي” لأدبها الذي يُقرأ وبشغف.
نحن لا يصلنا كل شيء، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه قرا كل ما طبع ورفع في رفوف المكتبات تحت مسمى رواية عربية، فاليوم نحن وأقصد بـ”نحن” جيل القاع، أي الجيل الذي يشهد انحدار الأمة وثقافتها إلى نقطة قريبة من القاع حيث الأمم الهزيلة المهزومة المتفرقة المتاحة للعبث بها من قبل أمم أخرى، نحن نائمون إلى أن يوقظنا واحد منا قرأ رواية لابراهيم نصر الله مثلاً فنستضيء بقنديل ملك الجليل أو نشارك في أعراس آمنة.
سأصل إلى مربط الخيل ههنا .. حقيقة النهضة والتطور المستديم المتكامل تكمن في الواجهة والمكاشفة والشجاعة .. مثلما فعلت السينما الأمريكية .. مثلما فعل الأدب الفرنسي قبل مئتي سنة .. لا زالت أقلامنا أقل مداداً من ريشة سرفانتس.
الأدب قبل بضعة عقود كان يمثل الإعلام والتواصل والثقافة والتوجيه السياسي والعلمي وسارية الفنون، إضافة إلى كونه أدباً، كان لدينا حينها طه حسين ونجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم، وغيرهم.
كانوا يعكسون المرايا من كل اتجاهات الأشعة، حتى أوشك بعضهم أن يُتهم بالعمى، رغم أنه فتح عيونهم على طرق في التفكير تحمي التراث الصحيح وتحرث الحقل لبذور النهضة.
إذن هي المصداقية .. المصالحة بين الكاتب والحقيقة أولاً، وليست المصالحة بين الكاتب والرقيب الأدبي، النظارة التي يجب أن يستعملها الكاتب ينبغي أن تكون طبية تصحح الرؤية وليست نظارة “فيميه” يضعها له صاحب المقص إياه، ليرى ويكتب ضمن الدوائر والمثلثات الواضحة على الخريطة الموقع عليها من قِبل .. من يوقّع عليها.
في صدفة تحدث كثيراً .. بدأت بقراءة حزامة حبايب .. كان اسمها قد مر علي قبل سنوات، لم اقرأها بناء على اعتباري من أولئك المنتظرين تشجيع وتحريض الآخر الذي قرأ فحكى لنا فحرضنا على القراءة.
قرأت “قبل أن تنام الملكة”، ثم قرأت لها أيضاً “مُخمل”.
وكوني من جمهور القراء .. الذين هم مثلي يدّعون الخبرة غير الرسمية وغير المعتمدة في القصة، أي نحن لا ندرّس النقد الأدبي في الجامعة .. ولم ندرسه. أقول لهم إن الطريق الصحيح في الرواية العربية لم نفقده بعد، والرواية العربية لم تفقد دورها بعد.
حينما كان المنفلوطي يترجم لنا فذلك لكي يُطلعنا على طريق النهضة الأوروبية، وحين كان جرجي زيدان يعيد كتابة فقرات من التاريخ بكراس القصة وبمنطوق عقله فإن يدلنا على حق كل منا في قراءة التاريخ حسب منطوق عقله، دون أن أضع القصة جانباً، ثم أحمل مسدساً وأشهره في وجه من يوالي اتجاهاً اختلف معه.
نحن في العصر الحديث وقعنا في أزمة تجهيل ممهنج، وقعنا في فخ الصراعات المتوالدة ذاتياً، وهذا الفخ له كهوف تحت أرضية، حيث ما زالت قصص الصراعات السياسية في القرون الوسطى في عصر الدولة العربية “والتي كان أغلبها مبنياً على أحزاب دينية” تملأ الفايسبوك، مما يعني أنها تخشخش في عقول كثيرة، وأقوال رموز تلك الصراعات تملأ البوستات، أي أن الكثيرين ما زالوا يصرون على الاستظلال بروايات الفرقة والتبعية والاستزلام.
عندما تقرأ حزامة تكتشف أن فلسطين حينما اقتُلعت نبتت في صدور الأمهات الفقيرات في المخيم وتنهدهم وبكائهم الصامت الغزيز، تكتشف أن العروبة في لحظة ما ليست أكثر من كالوس جانبي في مسرح، وأن القضية الفلسطينية ليست سوى قضية فلسطينية وكل ما يقال إنها قضية عربية كبرى فهو فقط يندرج ضمن الإعلام التعبوي الممتاز التاريخي الأرجواني المزركش وعليه تنتنا.
التفاصيل الدقيقة، حيث تقرأ حزامة حبايب، توشك أن تصبح خياطاً أو نجاراً أو سائقاً أو فدائياً أو طباخاً أو طبيباً أو مترجماً .. تُعيد فهمك للناس، تُراجع مسلماتك عن الأشخاص، عن السيدات، عن الأمهات، عن الآلام، عن المخيمات، عن النكبة، عن الدين والمتدينيين، عن الشوام وأهل الخليج، والعراقييين، تخبص في أوحال “البقعة” وتركض على أرصفة “حَوَلّي” وتستاف غبار الحدود الصحراوية بين الدول العربية، تتخيل البويك والشيفروليه القديمة، تتلمس المخمل، وتتذوق الكفتة بخبرة فلسطينية، والجبنة أهم شي الجبنة الفلسطينية، والنابلسية الأصيلة.
هناك محاكمة مستمرة للرجل في أدب حزامة، وهذا ممتع وضروري، وهناك نتيجة نهائية تتوافق مع نظرية أطلقتها قبل الأزمة السورية .. نظرية شهيرة جداً “يعرفها فقط بعض أصدقائي وأنا”، إن الفلسطينيين لو نجحوا في الاستقلال بدولتهم، حتى لو كانت مساحتها أقل من نصف فلسطين التاريخية، فإنها ستكون أكثر دولة متقدمة في المنطقة بغضون سنوات قليلة، بسبب كثرة الكوادر والكفاءات الحقيقة المتقدمة في كل شيء.
أي إنسان .. حزامة حبايب قادرة أن تضعه تحت سارية قلمها الوصاف .. الذي يشبه “سْكانر” فهي تقرأ كل شيء في المشهد … ثم تكتبه لك فتجد نفسك وبهدوء تحت سقف البيت مع الأحداث، وحول المخيم، أمطار القرية، “طوز” الخليج، قيظ الصحراء، عطور، عبوس، عيون وأفواه وأذرع وقامات وبطون ونوافذ، أنت حاضر مع أبطال الرواية .. تكاد تنظر في أعينهم، وتتذوق طعامهم، وتراقب سيماء وجوههم، فقط أكمل القراءة.
ما زلت أقرأ لحزامة، وسأكمل ما كتبَته قبل المُخمل وقبل أن تنام الملكة، فالرواية العربية على الطريق الصحيح.
.
*كاتب ومعد برامج تلفزيونية – سوريا