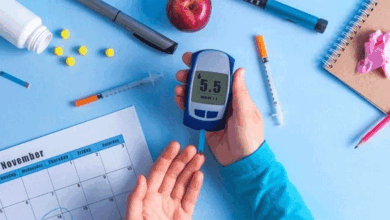عن عيدِ الجلاء والسياساتِ الثقافيّةِ .. د.إنصاف حمد ..
عن مركز دمشق للأبحاث والدراسات - 2020

يُعَدُّ يوم جلاء المستعمر الفرنسي في 17 نيسان 1946، العيد الوطني لسورية الحديثة التي نعرفها: الدولة المستقلة ذات السيادة بحدودها الحالية المعترف بها. وهو حدث تأسيسي بهذا المعنى، غادرت فيه جيوش الاحتلال أراضي الجمهورية العربية السورية، بعد أن أجبرتها على ذلك مقاومة مستمرة لم تهدأ على امتداد مساحة سورية، شمالاً وجنوباً/شرقاً وغرباً، قدّم فيها السوريون تضحيات جمّة على مذبح الاستقلال، وأظهروا إرادة صلبة لإفشال كلّ محاولات التقسيم والتفتيت التي عمل عليها المحتل، ما أرغمه في النهاية على اتخاذ قرار الجلاء.
ليس المقام هنا هو الحديث عن مجريات ذلك الحدث المفصليّ، وهو موضوع جرى فيه حديث كثير، وإن كان يحتمل المزيد من الدراسات والتقصي للكشف عن صحائف لم تَنَل ما تستحقه من اهتمام؛ وقد غدا جزءاً أساساً من أدبيات التاريخ الحديث لسورية، ومكوناً مهماً من الدرس التربوي في منهاج التربية الوطنية والتاريخ.
الحديث هنا يعمل على أن ينحو منحى آخر يتبنى مقاربة مختلفة، وإن كانت تتضمن النواة الصلبة ذاتها، فالأمر لا يدور حول الحدث ذاته؛ بل حول الاستثمار في هذه المناسبة/الذكرى، كجزء من السياسات الثقافية الواجب اعتمادها لتكريس ذكرى الجلاء، بوصفه أحد عناصر السردية السورية الكبرى التي تشكّل نسيجاً ضامّاً لهوية سوريّة جامعة وموحدة، هوية كشفت وقائع الحرب على سورية عن جوانب غموض ولبس يكتنفانها، ويضفيان عليها ملامح ارتباك وتشوش وعدم يقين؛ ولعلّ هذا، بالإضافة إلى عوامل عديدة أخرى، يُعد نتيجة –بمعنى من المعاني– لخلل وقصور في السياسات الثقافية المتّبعة، التي لم تُعطِ عوامل الوحدة بين السوريين –ومنها حدث الجلاء– ما تستحقه من اهتمام، ما جعل الهوية الوطنية السورية تكابد استحقاقات التعيّن بين قطبي رحى البارديغم القومي والبارديغم الديني، حتى تكاد تتلاشى وتذوب بينهما .
وفي السياق ذاته، لم تولِ السياسات الثقافية حدث الجلاء أهميته كما يجب، ولم تعمل على الاستثمار فيه ليغدو، قولاً وفعلاً، أحد عوامل الوحدة بين السوريين، ليس فقط بوصفه حدثاً تأسيسياً؛ بل أيضاً بصفته موضع إجماع مشترك بين أعضاء “الجماعة السورية” بأهميته ورمزيته ومرجعيته، وبوصفه حدثاً اشترك جميع السوريين في صنعه بمختلف مناطقهم وانتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية، وهذا ما يؤهله لأن يكون مدماكاً أساساً في الهويّة الوطنية السورية، وعاملاً كاشفاً عن مدى تشارك الذاكرة الجمعية للسوريين على تعددها وتنوعها.
هذا، ورغم مضي 74 عاماً على هذا الحدث، إلا أن الاستثمار فيه اقتصر على آليات أفرغته من معناه “الموحد” ومن رمزيته “الجامعة” ومن فعله “الضام”، ولم تعمل على أن يكون جزءاً “حياً” و”معاشاً” من السردية السورية الكبرى بالمعنى الفعليّ. تحوّل يوم الجلاء إلى يوم عطلة عادي وروتيني كبقية العطل، ويقتصر الاحتفال به على احتفالات رسمية جداً، جامدة ومغلقة ومكررة إلى حدّ الملل، بحضورها “الملزم” وخطابها الإنشائي ومجرياتها المكرورة؛ ولا تخرج الاحتفالات التي تقام في المدارس عن هذا المنوال، حتى غدا الاحتفال بهذا اليوم قالباً صورياً يكاد يخلو من المضمون “الحي”، ولعل هذا من الأمور التي تمكنُ ملاحظتها بوضوح في موضوعات التعبير التي يطلب إلى التلاميذ كتابتها في هذه المناسبة، وبقدْر مشابه للمقالات الصحافيّة التي يدبجها الكتّاب كنوع من “الواجب” لا أكثر .
تصبّ الأنشطة الثقافية والبرامج الإعلامية إلى حدٍّ كبير في هذا الاتجاه، محاضرات أو ندوات أو مقابلات مع شخصيات “مستهلكة” إعلامياً وثقافياً، تكرر الخطاب ذاته بصيغ مختلفة، حتى البرامج التي تستضيف من بقي من سوريين شاركوا بشخوصهم في الحدث، وعلى أهمية فكرتها، إلا أن إعدادها والشغل الفني عليها لا يعدو أن يكون من قبيل الشغل المناسباتي السريع الذي يخلو من الصنعة الفنية والإبداعية، ما يجعل من متابعتها أمراً شاقاً ومنفّراً. ولا تكاد الذاكرة القريبة أو البعيدة تستحضر عملاً فنياً، تمثيلية أو مسلسلاً أو فيلماً، ارتقى إلى مقاربة مكانة الحدث وأهميته، واستطاع أن ينعش الذاكرة الجمعية السورية ويثريها (ربما يحضر كاستثناء هنا فيلم الفهد الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما عن رواية لحيدر حيدر، ومسلسل أيام الغضب، وأحد أجزاء مسلسل حمام القيشاني).
في ضوء ما تقدم، ربما حان الوقت لأن نقوم، في ما يتصل بالاحتفال بذكرى الجلاء، بـ (اختراع التقاليد) وفقاً لتعبير إريك هوبسباوم، وهذه مهمة ينبغي أن توليها السياسات الثقافية الأهمية التي تستحقها، نظراً لما يمكن أن تضطلع به من دور في تمتين النسيج الهوياتي السوري، بعد أن عانى ما عاناه جراء تبعات الحرب ونتائجها.
والحديث هنا يتصل بالعمل على إخراج مناسبة الحدث من قالبها المناسباتي الجامد والخالي من المضمون الحي، عبر تحويل الاحتفال بذكرى الجلاء إلى طقس شعبي وجماهيري عام، ليغدو حدثاً حيّاً ومُعاشاً بكل ما في الكلمة من معنى، يندفع السوريون بكل حماسة إلى المشاركة به، ويغدو تدريجياً مناسبة سنوية لتجديد “عفوي” ومستمر لعقدهم الاجتماعيّ كجماعة سورية.
ويمكن أن يغدو ذلك ممكناً ومتاحاً إذا وُضعت الخطط واستُنفرت الجهود لإعادة الحياة إلى هذا اليوم و”إضفاء المعنى” عليه، عبر تنظيم احتفالات شعبية عارمة في الساحات والميادين كافة، من أكبرها وأكثرها رمزية، إلى أصغر ساحة في أبعد قرية أو تجمّع سكاني، بحيث يغدو هذا تقليداً سنوياً تشترك في الدعوة إليه وتنظيمه والمشاركة فيه الفعاليات الرسمية والشعبية، جنباً إلى جنب، وبشكل أفقي يمحو الفوارق بين الناس ولا يجعل الرسميين يتصدرون المشهد. يمكن أن تترافق هذه الاحتفالات بمجموعة من “الطقوس”: كإطلاق الألعاب النارية الملونة بلون العلم الوطني، وارتداء ملابس بألوان العلم أو أحدها، ورسم العلم على الوجوه، وإنشاد النشيد الوطني والأهازيج الشعبية التي أبدعتها الذاكرة الجمعية في كل المناطق بصدد هذه المناسبة. ويكون ذلك على أنغام الأدوات الموسيقية الشعبية المتاحة كالطبل والزمر والناي والدربكة وغيرها.
وعبر مشاركة الجميع، أطفالاً وشباباً وشيوخاً، نساءً ورجالاً، أناساً عاديين وفنانين ومشاهير وقادة رأي، يغدو من الممكن أن تتحول لحظات الاحتفال إلى مساحة لخلق الفرح المشترك، ولاستعادة تلك اللحظات المجيدة من تاريخ سورية بطريقة غير تقليدية، تُعيد إضفاء المعنى الحقيقي والأهمية المطلوبة على فكرة مقاومة المحتل في كل آنٍ وأوان، وعلى أهمية حماية البلاد والحفاظ على استقلالها وسيادتها، وإنجاز جلائها المتجدد من كل الاحتلالات الراهنة. وبذا تستمر فكرة الجلاء في استكمال حمولتها الفكرية والسياسية. ويخلق التقارب الفيزيائي والمشاركة في الفعاليات إحساساً بالتضامن والتشارك التام –وعلى قدم المساواة– في جماعة واحدة وهوية واحدة. ويؤدي النقلُ المباشر لهذه الفعّاليات عبر وسائل الاتصال والإعلام دوراً في توسيع مساحة هذا الشعور ليشمل مساحة الوطن بأكمله .
أخيراً، يستحق حدث الجلاء أن يتحول إلى عيد للسوريين يكون “جامعاً ومانعاً”، بلغة المنطق، بحيث يعيد تعريفهم من جديد بمدّه أواصر القربى المعنوية بينهم، وهو جدير بهذا وخليق به، من حيث إنّه، بمعناه ورمزيته وسرديته ومرجعيته، يمكن له أن يجمع كل السوريين تحت عباءة سورية، ويمنع أي دخيل من الولوج فيها.
باختصار، إنه عيدنا وحدنا، ولنا كلنا، نحن السوريين.
*باحثة وأكاديمية سورية – دمشق
المصدر : مركز /مداد/ نيسان 18, 2020